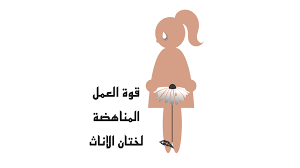دراسة نقدية لمسألة العنف القائم على النوع الاجتماعي بالمغرب

(أحمد الخراز)
دراسة نقدية لمسألة العنف القائم على النوع الاجتماعي بالمغرب على ضوء مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
أحمد الخراز
قراءة في سياق التنزيل:
تمخض الجبل فولد فأرا، مثل بات يختزل الكثير من طرائق وضع و تدبير و تصريف مجموعة من السياسات العمومية التي انخرطت الحكومة في تبنيها على مستوى التصور و الأجرأة، بعد إرفاقها بضجيج الدعاية الإعلامية و التسويق السياسي. و الواقع أن الارتباك البيّن و الارتجال الواضح هما ما باتا يميزان الأداء الحكومي المفارق أصلا لروح التعاقد السياسي و الالتزام الأخلاقي، في إطار البرنامج الحكومي الناشئ عن علاقة تعاقدية بين الحكومة و المواطن/الناخب.
و لعل هاجس البحث عن منجز أو“أزمة الإنجاز” هو ما بات يحكم العمل الحكومي و يرهن خلفياته، و يوجّه مساراته نحو تحقيق الكمّ على حساب الكيف، و هذا ما يبدو جليّا من خلال استقراء و تقييم مجموعة من المبادرات التشريعية التي انخرطت فيها السلطة التنفيذية في تعدّ صارخ على حدود السلطة التشريعية.فالتعجيل بإخراج مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يدخل في سياق البحث عن إنجاز ما، قد يحفظ ماء وجه الحكومة التي أسست خطابها البرنامجي على أولوية القضايا الاجتماعية، و بالتالي قد يعيد لخطابها بعضا من المصداقية المفتقدة.
لكن، و رغم الطابع الإستعجالي لمثل هذه القوانين، إلا أن تسريع وتيرة إخراجها لا يجب أن يكون على حساب الجودة و الفعالية و الواقعية. كما لا يجب على الحكومة أن تنظر بعين المزايدة السياسية فتُخضع القضايا الاجتماعية ذات الحساسية، لمنطق الربح و الخسارة في معاركها السياسوية الفارغة. كما أن الإخراج السريع لمشاريع القوانين لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يغفر رداءة موادها و غموض مقتضياتها، و لا أن يشفع ما قد يشوب صناعتها من نقص أو عيب أو شذوذ أو إبهام. فصناعة التشريع تستوجب ضوابط صارمة تتحدد من منطلق خصوصية اللغة القانونية، و دقة مصطلحاتها وحصر مجالات تفسيرها مع ضرورة تحقق الوضوح، و التبسيط و السلاسة تلافيا للّبس، و رفعا للغموض و دفعا لأي تأويل أو تفسير مغرض، قد يُستشف من منطوق المتن فيُحاجج به في غير محله.
و لعل ما يعاب على تشريعنا الوطني، هو ما يلحق أغلب نصوصه-في نسختها العربية- من غموض ناتج عن تعقيدات اللغة جراء الترجمة الركيكة، التي تفقد النص إحكامه و اتساقه و وضوحه. فكيف السبيل إلى نشر المعلومة القانونية و تحقيق رهان التثقيف القانوني لشعب تنخره الأمية إن كان النص القانوني منيعا على فهم العامّة؟ مما يسقطه في النخبوية الضيقة، بل إنه في بعض الأحيان يُستعصى فهمه حتى من قبل الباحث المتخصص.
و رغم ما جاء في مذكرة المشروع التقديمية، من كون الغاية الأساسية من هكذا مشروع، هي تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك و واضح [1]. إلا أن الصياغة المعيبة للنص تدحض كل هذا، بدءا من العنوان غير المتّسق و المفارق لمضمون المشروع قانون 103.13. إذ كيف أمكن لواضع هذا الأخير أن يدمج الأطفال على اختلاف جنسهم تحت يافطة النساء؟ ماذا كان سيضيره لو أنه أضاف لفظة الأطفال إلى جانب النساء كعنوان مقترح للمشروع؟ خاصة و أن نصف مواد المشروع تتحدث عن النساء و الأطفال معا. و لعل خلوّ ديباجته من عبارة الأطفال و اقتصارها على ذكر النساء فقط ليطرح تناقضا غير مفهوم، يعكس خللا في الرؤية و ضبابية في التصور. الأمر الذي يذكي فرضية الانفصال التام بين روح الديباجة و مقتضيات المشروع، كما لو أن الأولى صيغت لمشروع آخر مختلف. خاصة بعد مطالعة مواد الباب الأول التي تلازمت لفظة النساء بالأطفال ضمن عناوينها الفرعية، بل أكثر من هذا، ما نلحظه و نحن نطالع فقرات المادة الأولى، التي أفردها المشرع لتحديد مفاهيم العنف و صوره، فباستثناء الفقرة الأولى التي تتحدث عن العنف الموجه ضد المرأة حصرا، نجد كل الفقرات التالية قد تضمنت ربطا عضويا متلازما بين النساء و الأطفال. فلماذا هذا الإقحام المغرض الذي من شأنه أن يكرس التمثّل النمطي المغلوط لدى المجتمع عن الرجل، باعتباره أداة لإنتاج العنف و تصريفه؟ كما لو أن الرجل كيان مفارق لواقعه و معاد لمحيطه، وجب تدجينه و ترويضه لإرغامه على التعايش القسري مع مكونات المجتمع الأخرى. فكيف لمشروع قانون يصدر عن وزارة تسمي نفسها بوزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية أن يكرّس لمنطق الإقصاء ضد الرجل بعد استعدائه بخلفية قدحية تعبئ النساء و الأطفال ضده؟ مع العلم، أن ليس الرجل وحده من يحتكر العنف كسلوك موجه ضد أطفاله، بل هناك عنف لا يقل فظاعة تمارسه النساء ضد أطفالهن في إطار العنف الأسري، بحكم طول المدة التي يقضينها برفقتهم في البيت مقارنة بالرجال.
لا يمكن أن نعيد إنتاج نفس المقاربة الإقصائية البائدة بتغليب طرف على طرف، و النهوض بحقوق المرأة، لا يجب أن يكون على حساب انتقاصها من الرجل، و إلا أعيدت نفس الدوالية المختلة. ففلسفة الاجتماع البشري تقوم على مفهوم التوازن لا الاختلال، فمتى فقدت المقاربة القانونية حيادها و تجردها، و تحكمت في إعدادها نوازع الانفعال و شرور الانحياز، أصابها الخلل فتفقد الرجاحة و المصداقية. و ما يؤكد هذا الانطباع هو ما نتلمسه من هاجس عقابي ظل يحكم مواد الباب الثاني المتعلق بالأحكام الزجرية، الذي يشمل كل التعديلات الملحقة ببعض فصول القانون الجنائي ذات الصلة. ما يجعل القارئ يشعر كما لو أن واضع المشروع، قد أعمى بصيرته القانونية جموح انفعالاته الوجدانية، فغلّبت لديه الرغبة في العقاب،على الرغبة في الإنصاف. أو لعله راهن على إعداد وصفة سحرية و ليس مجرد إطار قانوني، قد تنقل في لمح البصر المرأة المغربية من وضعيتها الصعبة، إلى وضع آخر أكثر كرامة و تكافؤا و أمنا. فوجد في تشديد العقوبات الجنائية الطريق الأقصر و السهل لتنزيل وصفته. و هذا ينمّ عن قصور معرفي حيال ظاهرة العنف و بنيات إنتاجه، و كذا للتعقيدات السوسيوثقافية التي تساهم بشكل كبير في إذكائه والتستر عليه، بل و التواطؤ الجمعي مع تمظهراته المستشرية في المجتمع، فمثلا إن كنا نتحدث عن العنف الممارس ضد المرأة في إطار الحياة الزوجية، فرغم أنه يشكل نسبة انتشار تعادل 55%، إلا أن نسبة التبليغ بشأنه للسلطات المختصة تظل نسبة ضعيفة جدا بحوالي 3%. و جدير بالذكر أن هذه التبليغات لا تهم إلا بعض صور العنف المبالغ فيه، و التي تلحق ضررا ماديا مباشرا بالضحية، بحيث تتصدر الاعتداءات بواسطة أداة حادة أو مادة خطيرة، الشكايات المبلغ عنها بنسبة 41,7% من مجموع الحالات، يليها الحرمان من الأطفال بنسبة 21,2% ، ثم الطرد من بيت الزوجية بـ6,9% [2]. هذه فقط عينة يمكن الاستدلال بها، على ما ذكرناه بخصوص نوع من التواطؤ المجتمعي مع الظاهرة. مما يعقّد مهمة الرصد و التتبع، إذ يجب التأمل عميقا في نسبة التبليغ الهزيلة، فرقم 3% من أصل 55% من مجموع حالات العنف الممارس في الوسط الزوجي تؤشر على أن الغالبية العظمى من النساء المعنفات 52% لا يبلغن عن العنف الممارس ضدهن، و هذا راجع لعدة أسباب يمكن مقاربتها على مستويات عدة:
أولا، على مستوى تمثّل العنف لدى الضحية كسلوك عدائي غير سويّ موجه ضدها.
ثانيا، على مستوى وعي الضحية بماهية العنف، و مدى قدرتها التمييزية على تصنيف سلوكات معينة ضمن خانة العنف أو اللاعنف، إذ لا يوجد تصنيف مرجعي يحدد مجموع السلوكات اليومية داخل الأسرة المغربية، و يصنف الأفعال و ردود الأفعال التي تقع بين الأزواج على مقياس العنف. الأمر الذي يستحيل معه تحديد مفهوم العنف كقيمة و حصر ممارساته، إذ يمكن لأية زوجة معنفة أن يلتبس عليها الوضع فتعتقد مثلا، أن إقدام الزوج على صفعها يدخل ضمن المناوشة البسيطة التي تقع بين الأزواج بشكل اعتيادي، و نفس الأمر قد ينطبق على أحد أخطر أشكال العنف الجنسي و يتعلق الأمر بالمعاشرة الجنسية بالإكراه، التي لا تمثل إلا8,7% من نسبة الانتشار، بالمقارنة مع فرنسا التي تصل فيها النسبة إلى 16%.[3] و هذا يجد تفسيره ربما في تغاضي النساء ضحايا هذا النوع من العنف، عن الجهر بممارسات أزواجهن الجنسية اتجاههن، نظرا لحساسية الموضوع المعتبر في حكم الطابوهات.
فضلا عمّا يلحق المرأة من عنف رمزي (الإهانة، الازدراء، التخويف و التهديد، الشتم..) و ما يترتب عنه من آثار نفسية فادحة عليها، و رغم خطورته إلا أنها لا تعيره اهتماما أصلا، فكيف لها أن تعتبره عنفا موجّها، و تبادر للتبليغ عنه؟
ثالثا، فالرقم يشير إلى معطى غاية في الخطورة، و هو ضعف ثقة المعنفات في السلطات القضائية و العمومية كجهات قادرة على حمايتهن و ضمان حقوقهن.
المرأة ضحية منظومة ثقافية و اجتماعية منتجة للعنف:
لعل العنف الممارس داخل إطار الزوجية، لا يعدو أن يكون مجرد الشجرة التي تخفي غابة العنف المتداخلة الغصون و المتجذرة الجذور، في البنية الثقافية المجتمعية التي تسوّغ لهكذا ممارسات. بل و تشرعنها من منطلق يستجيب و ينضبط للهيمنة الذكورية، و يبيح إلى حدّ ما بعضا من الممارسات العنفية المترسخة في النسيج المجتمعي، الذي تعتبر الأسرة إحدى مكوناته. فكيف لثقافة تستمد مرجعياتها من مقولات قيمية، تحرض على العنف بل و تبرره، باعتباره نمطا اعتياديا للتعايش الأسري، و ضرورة حياتية تحكم العلاقات الإنسانية المشتركة، أن تؤسس لمجتمع اللاعنف؟ فمثلا ثقافتنا حبلى بمقولات شعبية تستوعب العنف و تكرس تطبيقاته، كما لو أنه ناموس وجود. فمثلا مقولة: “حتى مصارين البطن تتعارك” تضفي نوعا من الشرعية الفيزيولوجية –إن جاز التعبير- على ظاهرة العنف، إنه إسقاط غير سليم يحاول التطبيع مع سلوك شاذ غير حضاري، وتضليل الناس بكونه سنة طبيعية تحكم الوجود الحيّ للموجودات. هناك أمثال أخرى تختزل سقف العنف الشعبي المحفوظ في ذاكرة المجتمع، لكنه ربما موجود في بذور كل أشكال العنف الذي تعاني منه المرأة اليوم [4]. و نسوق بالمناسبة بعضا من الأمثال العربية و المغربية الدارجة، و كذا الغربية للتدليل على كونية الخطاب التحقيري للمرأة، الذي تخطى حدود كل الثقافات الإنسانية، فمثلا في المثل الشعبي العربي نجده حينا يصور المرأة بكونها ضعيفة الحيلة كـ“البنت جناح مكسور”، وتارة بكونها إحدى مصائد الشيطان للإيقاع بالرجال في المعصية كـ“النساء حبائل الشيطان”، ويصل خطاب التحقير أقصى درجات الدونية، حينما يفاضل بينها و بين حيوان مذموم اشتهر في الثقافة الشعبية بالمكر و الخبث، كـ“صوت حيّة و لا صوت بنيّة”..أما في الموروث الشفهي المغربي فنجده أكثر غنىً بصور تضجّ باحتقار المرأة و اضطهادها، أو التحذير من كيدها، و لنا في مخطوط عبد الرحمان المجذوب[5]. الذي تناقلته الأجيال فيما بينها كإنجيل منزّل، المثال البيّن على إرث مثقل بالإهانة و الدونية يحطّ من المرأة حينا، و يشيطنها حينا آخر.
إن تراثنا اللفظي المحقّر للمرأة يمتحي غالبا معانيه الدلالية من معجم الحيوانات، فيقع تشبيه المرأة بالأفعى كما ذكرنا سابقا، و بالبهيمة كـ“المْرا كتْرْبط من لسانها، والبهيمة تُربط من لجامها”، و بالقردة كـ“سعد البلدة كيْرْد العروسة قردة، والعكوزة جلدة”..إلى جانب تشبيهات أخرى تتوسل قاموسا غيبيا، كاعتبار المرأة نسخة إبليس البشرية، و لا ننسى أثر بعض القراءات المغلوطة المستندة على تأويلات متخلفة، منغلقة و جمودية لبعض نصوص الدين، كمسألة “الضلع الأعوج” و “الكيد العظيم”، في تكريس النظرة الدونية للمرأة و إسباغها بشرعية القداسة، و من هنا تبدو مقاربة مسألة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، مسألة في غاية التعقيد و الحساسية، و لعل المدخل الصحيح لأية مقاربة لابد و أن يصطدم بالموروث الثقافي الشعبي و التراث الديني المغلّف بطابع القداسة، و الأخطر أن يصير خطاب تحقير المرأة و التحريض عليها، خطابا يستمد هو الآخر قدسيته من داخل هذا الجزء المعادي للمرأة من داخل منظومة تراثنا الديني و موروثنا الثقافي و القيمي.
إنها أمثال تربط الصفات السيئة بالمرأة، وتقلل من شأنها وتطلب على الأخص الحذر منها لدرجة ربط ذكرها بذكر الشيطان وأسماء الحيوانات. إنها أمثال تدخل في نسيج المفهوم الشعبي للعنف المعنوي والنفسي واللفظي، الذي يمارس ضدها، والذي هو من أكثر أنواع العنف رواجا ومشروعية على الإطلاق. انه عنف جاهز تحت الطلب له مبرراته و قاموسه الكبير ومصطلحاته وبالطبع أمثاله. انه عنف استهلاكي عالمي وليس فقط من “صنع الشرق”. فيه نشتم رائحة التمييز على أشده [6]. فكل الثقافات الأخرى لم تسلم من سموم الخطاب الحاطّ من كرامة المرأة، فمثلا نجد المثل الفرنسي القائل: “المرأة الجيدة تعني الخادمة الجيدة”، و آخر ياباني يشيطن المرأة فيقول: “الشيطان أستاذ للرجل و تلميذ للمرأة”، و في نفس السياق يذهب المثل البولوني القائل: “ولدت المرأة قبل الشيطان بثلاثة أيام”، و حتى لدولة مثل بريطانيا نصيبها من هذا الموروث المعادي للمرأة، فنجد مثلا يشيّء إنسانيتها، و يشبهها بالجسور فيقول: “النساء و الجسور بحاجة دائما للترميم” [7].
إن هذه الأمثال توثق في الحقيقة لمشروعية احتقار المرأة ونبذها وتكريس دونيتها، كما أنها تشي عاليا باختلال التوازن والانعدام الهيكلي للمساواة بينها وبين الرجل*، و قد استقينا جملة من المقولات الشعبية التي تساهم في بناء التمثلات الجمعيّة حول المرأة في مختلف الثقافات الإنسانية، خاصة مع استحضار أهمية الدور التنشئاتي الذي تلعبه الأمثال الشعبية في البناء النفسي للفرد داخل مجتمع ما، على اعتبار أن المثل “أسلوب تعليمي ذائع” بحسب آرثر تايلور، وهو “من أبلغ الحكم لأن الناس لا يجتمعون على ناقص أو مقصر في الجودة” [8].
و إن كانت الدول الغربية قد قطعت أشواطا كبيرة في تبني سياسات عمومية في مجال الوقاية من العنف، و حماية النساء و تكريس المساواة التامة، و تجريم كل أشكال العنف و التمييز الممارسين على أساس النوع، فإنها حققت ذلك عن طريق اجتثاث منظومة العنف من جذورها، بدءاً من تنقية تراثها من الخطاب التحريضي الموجه ضد المرأة، و نشر ثقافة حقوق الإنسان في شموليتها، كما هو متعارف عليها كونيا، و توسيع و تقوية هامش دولة القانون و المؤسسات، و تحقيق أعلى درجات اليقظة و النجاعة القضائية في هذا المجال. إلى جانب تقوية و دعم المجتمع المدني الذي بات يحظى بدور رقابي، يوازي عمل أجهزة الدولة المختصة في رصد و تتبع حالات العنف، و التدخل الفوري لمواجهتها، وتوفير الدعم و الحماية لضحاياها. في إطار إستراتيجية متكاملة و شاملة و معقلنة ترتكز على تعزيز القيم و السلوكيات المجتمعية الإيجابية، و تقوية الإمكانيات الوطنية لتوفير خدمات شاملة للمعنفات، و بناء الإرادة السياسية و القدرة القانونية لمناهضة أشكال هذا النوع من العنف، بالإضافة إلى إجراءات أخرى بنيوية و قانونية وهيكلية لا مجال للتفصيل فيها الآن. فإن المغرب حاول اختزال كل هذا التراكم في إطار متن قانوني أعرج، و الذي على علاّته الكثيرة فإنه حتماً لن يجد طريقه للتنزيل، على غرار ما سبقه من برامج و مخططات، ظل المغرب يراوح مكانه و يتعثر في مسار أجرأتها لسنوات طويلة، ثم أتت النتائج مخيبة للآمال.
برامج بالجملة و الحصيلة هزيلة:
لعل الإنكباب من خلف المكاتب المغلقة على إعداد التصورات القانونية و برامج العمل و المخططات، و الاقتصار على إخراجها جبرا للخواطر و فقط، دون مراعاة الإمكانيات الكفيلة بتنزيلها على أرض الواقع، ليفقدها (التصورات) روح الحياة. و بالتالي نكون أمام قوانين ولدت ميتة بعد مخاض طويل. فاعتماد مجموعة من البرامج و القوانين، التي تهم مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي وحده لا يكفي، مادامت المصاحبة الإجرائية و الهيكلية لهذه القوانين لازالت معطلة، إلى حين توفر إرادة سياسية جادة للدولة للقطع مع كل أشكال العنف ضد النساء، و ما يؤكد غياب هذه الإرادة هو الفشل الذريع الذي تمنى به كل البرامج المعتمدة من طرف الدولة على مدى عقود في هذا المجال. لقد كانت الحصيلة مخيبة للآمال، و هذا باعتراف ما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون 103.13 التي عزت أسباب نزول هذا الأخير، إلى الوضعية الصعبة التي مازالت المرأة المغربية ترزح تحت نيرها، رغم ما بذل من مجهودات حكومية على مدى عشر سنوات، توّجت بمجموعة من الإستراتيجيات و خطط العمل، كالإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، مدونة الأسرة، مجموعة القانون الجنائي ، مدونة الشغل، قانون الجنسية، و الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” في أفق المناصفة 2012-2016، إضافة إلى مصادقة المغرب على اتفاقية محاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). إلا أنها جميعا تظل دون مستوى التطلعات، بسبب محدودية هذه التدابير و الإجراءات في حماية النساء من ظاهرة العنف التي تكتسح مزيدا من الفضاءات و المجالات، و يزداد عدد ضحاياها اطرادا يوما بعد يوم [9]. ولعل مكمن الخلل في كل هذه البرامج الحكومية و القطاعية السالفة الذكر، يرجع بالأساس إلى عدم استنادها على أربع دعائم أساسية تتمثل في الوقاية من العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، و ردع مرتكبيه، و التكفل بضحاياه، و كذا دعم المجتمع المدني و الارتقاء بدوره أكثر واعتباره شريكا رئيسيا و فاعلا في إعداد و أجرأة كل الاستراتيجيات المعتمدة في هذا المجال.
من هذا المنطلق نخلص إلى المعطيات التالية:
– أولا، بواعث إعداد المشروع انبنت على فشل المخططات و البرامج السابقة بعد دراسة نتائجها و تقييمها.
– ثانيا، غاية المشروع هي إحداث نقلة نوعية لوضعية المرأة المغربية، و تجاوز الاختلالات الراهنة لوضع أفضل مستقبلا.
– ثالثا، اعتبار مشروع قانون 103.13 بمثابة صك الخلاص للمرأة المغربية مما يلحقها من عنف موجه.
– رابعا، تحقيق المواءمة بين التشريع الوطني الخاص بحماية المرأة من كل أشكال العنف، و التزامات المغرب الدولية في هذا الشأن.
– خامسا، امتثال المشروع قانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، لروح الدستور الجديد عبر استيعاب مقتضياته و استلهام أحكامه و تنزيلها.
فهل نجح المشروع في تحقيق كل هذه الرهانات إلى جانب الغايات و الأهداف الأخرى التي سطرها واضع المشروع؟
صياغة معيبة و خلل في الرؤية و قصور في المضمون:
تحدثنا سابقا، عن رصد أولى العيوب الشكلية التي تطالعنا بدءا من الصياغة المعيبة و المموّهة لعنوان المشروع، و التي تخفي قصورا في التصور الصحيح لمفهوم العنف و تمظهرات صوره، هل نتحدث عن عنف قائم على أساس النوع الاجتماعي، أم أنه عنف أسري يطال علاقة الرجل بالمرأة في إطار تعاقدي و شرعي و داخل فضاء محدد؟ أم نتحدث عن عنف يطال المرأة و الأطفال بوجه عام؟ إذ و كما أشرنا سابقا، فلا يمكن إلحاق الأطفال –هكذا قسرا- بالنساء، ثم لا يمكن إفراد تسع مواد للحديث عن النساء بمعية الأطفال في حين يتم إقصاؤهم من الذكر في باقي مكونات المشروع ( عنوان، ديباجة، أبواب أخرى). و من شأن هذا الاختلال أن يحدث التباسا أولا، في ذهن قارئ المشروع، و ثانيا على مستوى نطاق تطبيقه و الفئة المستهدفة منه، و المشمولة بمقتضياته.
فمضمون المشروع قانون يشمل عنفا ضد فئات أخرى، من قبيل الأطفال و الأصول و الكافلين، بينما تسميته تحيل على جنس المرأة الخالص. و هذا راجع في رأينا إلى سببين اثنين، أولاهما هاجس التسويق السياسي للمشروع الذي حاول ذر الرماد في عيون الجمعيات الحقوقية الوطنية و المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن المرأة، خاصة بعد طول ترقب الإفراج عن قانون محاربة العنف ضد النساء. و ثانيهما، الخلل على مستوى منهجية الإعداد، الذي انعكس سلبا على جودة الصياغة، خاصة و أن المشروع قانون 103.13 كان ثمرة شراكة بين وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية، و وزارة العدل و الحريات، و هنا نفتح قوسا يسائل مدى نجاح و مردودية تجربة مثل هذه الشراكات القطاعية في مجال التشريع بالمغرب؟ هل تحقق الأهداف المرجوة منها؟ و هل يمكن اعتبار نتائجها معيار نجاح إو إخفاق على مستوى الالتقائية في السياسة التشريعية الوطنية بين قطاعين أو أكثر بالنظر إلى جودة النص و فعاليته؟
ثم عندما يقتحم المشرع مجال الفقه، و يبدأ بإعطاء التعاريف و تقديم التفاسير،فهذا اعتداء بيّن على إحدى أهم مجالات الفقه القانوني و أكثرها حساسية و حيوية، فلا يمكن إنتاج التعاريف على مقاس السلطة التنفيذية تلافيا لابتذال المصطلحات أو تسييسها و إخضاعها لمنطق الإيديولوجية.
و إن كنا نرفض هذا التداخل بين اختصاص الفقه و السلطة التنفيذية، فإننا نسجل “إغفال” واضع المشروع لإعطاء تعريف محدد بما قصده بـ“التكفل”، خاصة و أنه ربطه بالنساء و الأطفال معا، في حين وجب التمييز بين أطفال النساء المعنفات و الأطفال المعنفين في حالات منفصلة، بل قد يكونون بدورهم ضحايا عنف موجه ضدهم من طرف أمهاتهم.
و بناءا على تعيين المقصود بلفظة “التكفل”، تتحدد مدى جدية الإرادة السياسية للدولة في تحقيق النجاعة و الفعالية على مستوى الالتزام بالتكفل، خاصة إذا ما استحضرنا هزالة تجربة خلايا التكفل بالأطفال و النساء ضحايا العنف، و ضعف آليات اشتغالها و محدودية نتائجها، فأكثر من ثمانين خلية موزعة بين المحاكم الوطنية تشكو من ضعف المعدات و وسائل الاتصال و نقص الموارد البشرية المؤهلة، و التجهيزات الخاصة بتسهيل الولوج لخدمات الخلايا، بالإضافة إلى محدودية بنيات الاستقبال في استيعاب النساء و الأطفال ضحايا العنف. خاصة بعد الارتفاع الكبير لعدد الشكايات المقدمة للنيابة العامة في هذا الشأن، و التي انتقلت من 639 شكاية سنة 2010، إلى 1400 شكاية سنة 2012 [10].
مقاربة مجزأة و محدودة لعنف شمولي متعدد:
انصرفت مذكرة المشروع التقديمية إلى وضع “إطار مفاهيمي محدد و دقيق، من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز و حصر الأفعال و السلوكات الداخلة في مجال العنف ضد النساء، و ذلك من خلال تحديد مفهوم العنف و مختلف أشكاله” [11]. لكن هناك صنوف أخرى من العنف يصعب حصرها أو تقدير حجم ما تسببه للمرأة من معاناة و استغلال و تحقير.. ما حدا بالبعض إلى تسمية هذا النوع من العنف بالعنف المشروع [12]، و هذا ينطبق على ما ذهبنا إليه سابقا حول عنف المتخيل الشعبي تجاه المرأة، عنف منفلت ينمو معنا و نتعايش معه دون أدنى شعور به، ينفث سمومه في قنوات قيمنا المجتمعية، و يغذي تمثّلاتنا الذهنية حول المرأة. و الأخطر أن ثقافتنا الشعبية التي تدخل في تكوين هويتنا تنهل من معينه، و بالتالي فلا سبيل لإيقاف عجلة إنتاج العنف من داخل قيمنا، من دون مقاربة سيكوثقافية و سوسيوقانونية شاملة، تحاكم هاته القيم من منطلق حقوقي و إنساني محض. يجب قبل كل شيء، غربلة ثقافتنا الشعبية، و تنقية تراثنا من كل الشوائب العالقة به، و التي تحط من كرامة المرأة، و تستبيح كيانها. أما التركيز على المقاربة الزجرية وحدها عبر تشديد العقوبات، و تجريم بعض السلوكات التي قد تبدو اعتيادية وفق النمط السائد من داخل منظومتنا الثقافية و الاجتماعية المريضة، دون مراعاة مبدأ التدرج في التجريم و التناسب بين العقوبة و الجرم، فستترتب عنه (التركيز) آثار وخيمة لن يتحملها النسيج المجتمعي الهش أصلا.
ثم هناك عنف تمارسه بعض أجهزة الدولة، كتدخل القوات العمومية لتعنيف المعطلات بشكل منهجي في بعض الحالات، دون مراعاة لمبدأ التناسب بين فعل احتجاجي له طابعه النسوي الخاص، و فعل تدخل قمعي عنيف لا يتحدد على أساس النوع الاجتماعي، و لا يراعي الفروق الفيزيولوجية و السيكولوجية للمرأة المحتجة، بينما المفروض أن يكون التدخل -متى كان لازما- محكوما بضوابط حقوقية و إنسانية و ليس بهواجس أمنية بحتة.
من جهة أخرى، عرّفت الفقرة الأولى من المادة الأولى من مشروع قانون 103.13 العنف بأنه: “كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بين الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”، و من هذا التعريف نطرح التساؤل حول شرعية ما تقوم به بعض المؤسسات التعليمية العمومية أو الخاصة، من فصل لتلاميذها على أساس الجنس؟ و يتعلق الأمر إما بفصل الذكور عن الإناث على مستوى الفصول الدراسية فقط، أو بفصل تام على مستوى المؤسسة التربوية و تخصيص كل مرافقها للإناث دون الذكور. و بالتالي ألا يعتبر منع الاختلاط عنفا بيداغوجيا و تربويا موجّها و قائما على أساس التمييز؟ بالنظر إلى أهمية المدرسة في تكوين و بناء شخصية النشء في علاقاته الاجتماعية، بل إنها تعتبر الحلقة الأهم إلى جانب الأسرة، في مسار التنشئة الاجتماعية للفرد، و تقويم سلوكه المجتمعي. فكيف يمكن قبول هذا النوع من التمييز القائم على الفصل الجنسي، في بعض مؤسساتنا التربوية؟
ثم هناك عنف آخر ترعاه المؤسسات السجنية و الإصلاحية في حق السجينات، فلاعتبارات سوسيوثقافية يعانين بدرجة أكبر من المعاملة المهينة و الحاطة من الكرامة (السب و النعت بنعوت بذيئة و مهينة) بدءا من مخافر الشرطة و انتهاء بالسجن من طرف بعض المشرفات على المعاقل الخاصة بهن، و خصوصا اللواتي اعتقلن بسبب الفساد أو الخيانة الزوجية. كما أن النساء اللواتي وضعن مواليدهن أثناء مدة الاعتقال، و اللواتي لا معيل لهن يعتمدن على الإعانات الشخصية لبعض الموظفين أو مدراء السجون،في بعض الحالات لإعالة أطفالهن و توفير الألبسة لهم[13]. بالإضافة إلى اضطرارهن للتخلي عن أبنائهن بسبب انتهاء المدة المسموح بها، مما يعرضهم لمخاطر الاستغلال و التشرد، خصوصا في حالة عدم وجود أقرباء أو تنكر هؤلاء لهم. ألا يمكن اعتبار هذا النوع من العنف، عنفا مؤسسيا يمارس داخل مؤسسات الدولة و بمباركة بعض موظفيها، أو بتواطؤ منهم؟
و نفس الانتهاكات تقع في بعض مشافي الأمراض النفسية و العقلية، و مراكز الإيواء التابعة للدولة، و التي تطالعنا بعض التقارير الصحفية عن الأوضاع الكارثية لنزيلاتها[14].
ثم هناك عنف آخر يتخذ صورة الممارسة اليومية في حق المرأة المغربية، الممتهنة لنشاط التهريب المعيشي، و ما تعانيه من صنوف المعاملة القاسية و الحاطة من الكرامة الإنسانية، عند معابر المدينتين المحتلتين كل يوم. و نفس الأمر ينطبق على عاملات الجنس اللواتي لا يستفدن من أي نوع من الحماية، بحكم مزاولتهن لنشاط يجرمه القانون، و يستقبحه المجتمع. الأمر الذي يجعلهن عرضة لأبشع أنواع الاستغلال و التحقير، في غياب ضمانات قانونية أو حقوقية، تحميهن أو على الأقل تضمن بعضا من أبسط حقوقهن المستباحة. كما يعتبر تلكؤ الدولة في تسريع وتيرة إخراج و تفعيل قانون يجرم تشغيل القاصرات، بالموازاة مع ضبط و تنظيم العلاقات الشغلية القائمة، بين العاملات المنزليات و مشغّليهن، من أجل إقرار الحماية الاجتماعية لهن، وتمتيعهن بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. عملا بالمادة 4 من مدونة الشغل. (يعتبر) نوعا من العنف، إذ يمكن اعتبار الفراغ القانوني المنظم لهذا النشاط عنفا قانونيا يطال هذه الفئات المستضعفة.
إلى جانب هذا، هناك عنف آخر لا يقل عن سابقيه في درجة إيذائه و بشاعته، إنه ذاك الذي يقع داخل أقبية الزوايا و الأضرحة، في حق النساء اللواتي يعانين اضطرابات نفسية، و اختلالات عقلية و سلوكية، و يتعرضن لممارسات شاذة مغرقة في الدجل و الإذلال، لا يقبلها المنطق الإنساني السليم. و مع ذلك فمصالح الدولة المعنية تتجاوز الحياد السلبي، لتقف موقف المتواطئ، بل و الراعي لثقافة الدجل و الشعوذة الممارسة داخل هاته الأماكن، بالإغداق عليها بالعطايا و الهبات، و توفير الحماية للقائمين عليها، و منحهم كل التسهيلات و الامتيازات لتغطية أنشطتهم المشبوهة، و أفعالهم الضارة بالسلامة الجسدية و النفسية للنساء المغرر بهن، أو المكرهات على فعل ذلك لأسباب عديدة. بينما الأجدى أن تجند الدولة كل مصالحها المختصة، بهدف تشديد المراقبة على هذه الأماكن، في أفق إغلاقها و نشر ثقافة العلم و المعرفة، و وضع البرامج التوعوية للتحسيس بمخاطر الدجل. و تعرية ما يقع في هذه الفضاءات المظلمة، و تفعيل الجانب الزجري لملاحقة أصحابها. خاصة و أن أغلب الضحايا هنّ من النساء، باعتبارهن الفئة الأكثر إقبالا على ارتياد هذه الأماكن مقارنة بالرجال، لعوامل سوسيوثقافية و نفسية كثيرة، لا مجال للتفصيل فيها الآن.
فهل لدى الدولة الإرادة السياسية الفعلية، للقطع بشكل جذري مع كل هذه الأشكال، و هدم كل الحصون التي يتحصن داخلها العنف؟ و هل فعلا، لديها الإرادة الحقة و الجرأة اللازمة، لاجتثاث كل تمظهرات العنف من منابتها، و تفكيك بنياته و تفجير حاضنات بيوضه، التي ألبسها المتخيل الجمعي لبوس القداسة؟
على الدولة أن تتحلى بالشجاعة و الحزم، فتضع يدها على مكامن العنف حيثما كانت، و تجند مصالحها و تعبئ إمكانياتها للحيلولة دون استفحال مظاهره أكثر. فليس التحرش الجنسي بالمرأة في الفضاء العمومي، أخطر عليها من بعض الممارسات الشاذة داخل الفضاءات المعتمة في حضرة الأولياء. كما عليها أن تدرك بأن محاربة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ليس شأنا قطاعيا و لا ورشا حكوميا، بل هو منظومة متكاملة، تستلزم وضع دراسات اجتماعية و ثقافية و نفسية، من أجل وضع إستراتيجية متكاملة، تقارب العنف كظاهرة مركبة في شموليتها، و معقدة في تمظهراتها. و ليس وضع الرأس في الرمال، و الاكتفاء بسنّ القوانين العقيمة، مادامت لن تجد طريقها إلى التفعيل، كغيرها من النصوص الأخرى.
التّلجين أو مقبرة الإصلاح:
لا غرو أن صياغة مشروع قانون 103.13، قد شابها الكثير من القصور و الغموض، كما نقصت مضامينها الجرأة و الواقعية المتوخين في هكذا قوانين، لكنها في المقابل حاولت تعويض هذا النقص، باعتماد آليات أخرى، كآلية العمل اللجاني أو التلجين، و آلية العقاب و الزجر.
لا يتناطح كبشان بخصوص حقيقة أن تكثيف الطابع اللجاني لأية مبادرة، من شأنه أن يعيق مجال سريانها و يعطّل مسار تفعيلها. فتعدّد اللجان يسقط كل محاولات الرصد و التتبع و الإصلاح، في سلبيات البيروقراطية، و بالتالي إبطاء كل إجراءات التدخل الفوري، بعد أن يعقّّد مساطر تفعيله، و يعرقل مسارات تطبيقه الناجع. هذا فضلا عن ارتهان العمل اللجاني لضوابط شكلية و فنية و إجرائية معقدة، بسبب عدد المتدخلين الكبير. فتفريخ اللجان بهذا الشكل المفرط، عبر تفرع لجنة وطنية مكلفة بقضايا النساء، إلى لجان جهوية و التي تتفرع بدورها إلى لجان محلية، يطرح سؤال التنسيق و المواكبة من جهة، و سؤال النجاعة و الحكامة من جهة أخرى. خاصة و أن هذه اللجان تضم مكونات قطاعية عديدة، تتباين خلفياتها و تختلف مرجعياتها، مما يصعّب مهمة تحقيق حد أدنى من الالتقائية فيما بينها، على مستوى التعاطي الإيجابي مع ظاهرة العنف. ناهيك عن الصعوبات المادية و اللوجيستية و البشرية، التي يجب على كل هذه القطاعات الممثّلة في اللجان تعبئتها، لضمان استمرارية انعقادها في الزمان و المكان المحددين.
و من اللافت أن مشروع قانون 103.13 لم يتطرق بوضوح كاف، لمسألة تعيين مقرات اشتغال هذه اللجان جميعا، بينما أوصى بإحداث خلايا للتكفل بالنساء و الأطفال، لدى السلطات المكلفة بالعدل و الصحة و الشباب و المرأة و الطفل، و كذا بمصالح الأمن و الدرك، و نصّ على ضرورة استقبال الضحايا في مكتب خاص مجهز بما يراعي حالتهم النفسية[15]، و السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القارئ، هو ما المقصود بشرط استقبال الضحية في مكتب خاص؟ ما طبيعة هذا المكتب؟ و ما المعايير الواجب توفرها فيه ليكون بالفعل مكتبا خاصا؟ و كيف يمكن تجهيزه على نحو يراعي الحالة النفسية للضحية؟ ثم هل فعلا تسمح الإمكانات البنيوية و البشرية لتلك المصالح، باحتضان خلايا التكفل و دعم آلياتها لتوفير الحماية و الدعم اللازمين للضحايا؟
نأخذ مثلا قطاع العدل، فجلّ محاكم المملكة تتخبط في مشاكل بنيوية و هيكلية جمة، ناهيك عن الخصاص الكبير في العنصر البشري، فقد أقرّ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن وزارته في حاجة ماسة حاليا إلى 14 ألف و 588 إطار في مختلف الاختصاصات [16]. الأمر الذي بات يعطّل مرافقها الحيوية، و بالتالي يعرقل الولوجية لخدمة العدالة، بل و يؤثر سلبا على الأداء القضائي بشكل عام. و هنا نطرح السؤال حول مدى قدرة القطاع على استيعاب التحديات المترتبة، عن التزاماته العضوية كمتدخل في هكذا لجان؟ و مدى كفاءة و كفاية إمكانياته البشرية و اللوجيستية لإنجاح هذا الالتزام؟
خصوصا و أن تجربة خلايا التكفل بالأطفال و النساء ضحايا العنف، لازالت تراوح مكانها. نتيجة ضعف الدعم من حيث توفير المقار و الموارد البشرية [17]. فضلا عن الخصاص الكبير في عدد القضاة، (فقط 3749 قاض بمعدل 12 قاض لكل 100000 نسمة)، و هي نسبة جد متخلفة عن المعدل المتوسط العالمي بالنسبة لعدد السكان، و التي تبلغ 1 قاض لكل 3000 نسمة،أما في بريطانيا التي يوجد بها أزيد من 50000 قاض، فالنسبة فيها تعادل قاض واحد لكل 2000 نسمة، و هو المعدل المثالي. و ما يزيد الطين بلّة تراكم القضايا والنوازل المعروضة على القضاء والتي تنتظر البث. ففي سنة 2011 فاق عددها 3 مليون و300 ألف ملف، تمّ البث في مليونين و200 ألف منها – أي ما يمثل 72 بالمائة – ويُرجع القائمين على الأمور هذا الوضع إلى قلّة المحاكم والقضاء والأطر المساعدة[18].
أضف إلى ما سبق، القصور الحاصل على مستوى البنية التحتية للعديد من المحاكم، الذي يزيد من معاناة العاملين في القطاع، و المتقاضين على حد السواء. إذ و حسب وزير العدل و الحريات[19] فإن وضعية 30 محكمة على الأقل في حاجة عاجلة للمعالجة، و على مستوى البنية التحتية المعلوماتية فإن 50 محكمة تنتظر أن تشملها عملية التحديث. كما يسجل نقص في تهيئة الشبكة الكهربائية للعديد من المحاكم، مع نقص في بنية الاستقبال، ففقط 50 محكمة تتوفر على بنية استقبال حديثة.
باستقراء بسيط لهذه الأرقام، نخلص إلى أن قطاع العدل بإمكانياته الحالية، لن يكون مؤهلا للإسهام الفعال و الجاد، في إنجاح تجربة اللجان المكلفة بقضايا النساء و الأطفال. و نفس الأمر ينسحب على باقي القطاعات المؤلفة لهذه اللجان، و إن بدرجات مختلفة.
و نستغرب كيف أسهمت وزارة العدل و الحريات، في صياغة و إعداد مشروع قانون 103.13، و إخراجه وفق هذه الصيغة. و هي الأدرى بمكامن الضعف و القصور في منظومة العدالة بشكل عام، و محدودية اضطلاعها بأدوارها الأصلية، فضلا عن تلك الجديدة المنوطة بها، وفق مقتضيات المشروع الجديد، التي لن تكون إلا عبئا إضافيا، ينضاف إلى كاهل الجهاز القضائي المغربي، في ظل الإكراهات الراهنة. و في غياب تأهيل و تخليق و تطوير القطاع. بموازاة مع إطلاق سياسة تحديثية شاملة لكل القطاعات الأخرى، من أجل إعدادها و تأهيلها للمشاركة الفعالة، في تقوية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة كل أشكال العنف ضد النساء. فالواقعية تقتضي وضع القوانين بما يتناسب مع إمكانات تفعيلها و أجرأتها على أرض الواقع، أما الاكتفاء باجترار النصوص القانونية دون تعبئة الموارد الكفيلة ببعث روح الحياة فيها، فهذا ضرب من الوهم و العبث.
تجاهل تام لدور المجتمع المدني و مصادرة حقه الدستوري:
لقد كان مشروع قانون 103.13 بحسب مذكرته التقديمية، ثمرة شراكة قطاعية، بين وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية، و وزارة العدل و الحريات. و إن كانت هذه الشراكة، لم تسلم من غموض ظل يكتنف طبيعتها، بعد ما شاب مردودها التشريعي الكثير من الاختلالات الشكلية و الموضوعية المرصودة على أكثر من صعيد. زد على هذا، المقاربة المنفردة المعتمدة في إعداد المشروع، و التي أقل ما يقال عنها، أنها مقاربة إقصائية تعاكس روح دستور 2011 الذي أولى أهمية كبيرة للمجتمع المدني، و أناط به مجموعة من الأدوار الحيوية في إطار الديمقراطية التشاركية، و ذلك بالتأكيد على حقه في تقديم العرائض و الملتمسات التشريعية و المساهمة في بلورة السياسات العمومية[20]. بل إن الفصل 13 ذهب أبعد من ذلك، و أوصى بإحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. لكن الواقع يبقى عنيدا حيث أثبتت الحكومة أنها لا تتمثل ما ذهب إليه الدستور،و بالتالي فهي تحتاج إلى مراجعة منظورها للمجتمع المدني بحس ديمقراطي، يتجه للقطع مع المنطق الأحادي في التعاطي مع قضايا الشأن العام، و يكرس التشارك بدل الهيمنة و الاستفراد.
إن منطق التدبير السليم يقتضي بداية، توفير البيئة المناسبة للعمل المشترك، بدل القفز على المراحل المنهجية الأولى، للوصول بسرعة إلى ارتجال مشروع قانون مختل. فالنتائج بالبداهة هي من جنس المقدمات، فإذا كانت آلية الإعداد مختلة، فإن الحصيلة بلا شك ستكون متواضعة.
لقد استطاعت بعض منظمات المجتمع المدني الناشطة في قضايا المرأة و العنف، أن تراكم على مدى سنوات من العمل الجمعوي الجاد، رصيدا لا بأس به من الخبرات و التجارب الميدانية في هذا المجال. نظرا لما تتوفر عليه من كفاءات بشرية متخصصة، و عمق نفوذها المجتمعي، بالإضافة إلى ما تتوفر عليه من معطيات و دراسات تؤطر عملها، كل هذا يجعل من مراكزها، القبلة الأولى للنساء ضحايا العنف. بالمقارنة مع تلك المعروضة على السلطة العمومية أو الجهات القضائية، و طبعا هنا لا نحاول القول بأن المجتمع المدني يمكنه أن يكون بديلا لمصالح الدولة المختصة، بل فقط نحاول إبراز حجم ثقة المعنفات، في ما توفره منظمات المجتمع المدني من خدمات الدعم و المساعدة و الرعاية، نظرا لعوامل عدة ليس أولها، عامل القرب و انغراس الجمعيات المعنية، في النسيج المجتمعي المنتج للعنف، و خبرة أطرها في التعاطي مع مختلف حالات ضحايا العنف. بالإضافة إلى عامل مهم، يتعلق بسهولة الولوجية للاستفادة من خدمات المساعدة و المواكبة و الدعم، و أحيانا حتى التكفل رغم ما تعانيه بعض الجمعيات من إكراهات مادية و مرفقية، تحد من مجالات تدخلها، و تقلص هامش استجابتها لكل الطلبات الواردة عليها. هذه عينة من الأسباب التي تفسر إلى حد ما، لجوء أغلب النساء المعنفات إلى جمعيات المجتمع المدني، مقارنة مع محدودية إقبالهن على السلطات المختصة، تلافيا لبطء المساطر و صعوبة إجراءات الولوج، و تعقيد أنظمة الاستفادة من الدعم و التكفل و الحماية. فبحسب نتائج البحث الوطني لانتشار ظاهرة العنف ضد النساء، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2011، فإن مآل أغلب الشكايات حول العنف الممارس في إطار الحياة الزوجية، تنتهي بتحرير محضر (25%)،أو بالصلح و التنازل عن القضية (38%)، لكن الرقم الذي يستوجب التأمل طويلا هو أن 1,3% فقط هي نسبة المعتدين الموقوفين على إثر هذه الشكايات،في حين أدين فقط 1,8% من المشتكى بهم. ولعل هزالة هذه النسب هي خير مجيب عن سؤال تدني نسب التبليغ عن حالات العنف القائم على أساس النوع، فإحساس الضحايا بانعدام الضمانات الكفيلة بحمايتهن من المعتدين عليهن، و كذا ضعف ثقتهن في مؤسسات الدولة القضائية و الأمنية، في إنصافهن و أخذ حقوقهن و التكفل بهن، و ردع مرتكبي العنف في حقهن، هو ما يفسر ضعف نسبة المبلغات من ضحايا العنف، التي تصل فقط إلى نسبة 17,4% من أصل 3,1 مليون إمرأة تعرضت للعنف في الأماكن العمومية، و تتدنى نسبة التبليغ أكثر في حالات العنف الزوجي، لتصل إلى حدود 3% من أصل 3,7 مليون معنفة[21] .
أمام هذا الوضع، كان من الأولى على الدولة، أن تعيد بناء الثقة بين مرافقها و مرتفقيها من النساء ضحايا العنف، لتشجيعهن أكثر على تبليغ ما يتعرضن له من ممارسات منافية للكرامة الإنسانية. مع توفير الحماية لهن، و التكفل بهن و دعمهن إن اقتضى الحال. و في اعتقادنا كانت أولى الإشارات الإيجابية، في مسار بناء الثقة، هي إشراك المجتمع المدني في بلورة مشاريع القوانين ذات الحساسية الاجتماعية و الثقافية، كهذا المشروع. فمن منطلق العمق المجتمعي لموضوع العنف المبني على النوع الاجتماعي، كان حريّا بالسلطتين الوزاريتين أن تبادرا إلى إشراك المجتمع المدني، في إعداد مشروع قانون 103.13، وفق مقاربة تشاركية و تفاعلية، استنادا لما أولته أسمى وثيقة في البلاد، لهذا الشريك الحيوي من أدوار اقتراحية، تسهم في تدبير الشأن العام.
و لعل واضع المشروع أراد تدارك هذا الإقصاء على مستوى الإعداد، فحاول تعويضه على مستوى المقتضى، و ذلك بالتنصيص في ذيل المواد 4 و 5 و 6، على إمكانية استدعاء بعض ممثلي المجتمع المدني، لعله بذلك يفلح في تلطيف حدّة هذا الاستفراد، لكنه يسقط مجددا في تبخيس الفعل الجمعوي و احتقار أدواره، فيقيّد هذا الاستدعاء بشرط تحقق الفائدة !
إن رهن تمثيلية المجتمع المدني داخل اللجان الوطنية و الجهوية و المحلية، المكلفة بقضايا النساء و الطفل، بتحقق الفائدة، ليخفي تحايلا مضمرا، يحاول عبره واضع المشروع تدليس نزعته الإقصائية، و تغطية تجاهله للفعاليات المجتمعية. فمن شأن هذا الربط المقيت بين تحقق الفائدة و حضور أعمال اللجان، أن يفضح نوايا الحكومة في الاستئثار بقضايا الشأن الاجتماعي، و احتكار مقاربتها بمنطق هيمني و حزبوي ضيق.
كما كان لافتا تذييل المواد 5 و6 و7 المتعلقة بتأليف اللجان المكلفة بقضايا النساء و الأطفال، بفقرات تشير إلى إمكانية استدعاء هذه اللجان، لأعضاء متطوعين من الشخصيات المعروفة باهتمامها بقضايا الصحة و المرأة و الطفل، و ممثلين عن الهيئات و المؤسسات التي ترى اللجنة فائدة في استدعائها. ما يمكن أن نسجله هنا، هو استعمال المشروع لتعبير فضفاض، يغيب عنه الوضوح و الدقة و الجرأة، فمن شأن عبارة ‘‘كما يمكن’’ أن تترك الباب مفتوحا على مصراعيه، أمام إمكانية إقصاء منظمات المجتمع المدني من حق التمثيلية داخل اللجان. كما أن لفظة ‘‘المنظمات’’ وردت حصرا في المادة الرابعة، المتعلقة باللجنة الوطنية المكلفة بقضايا النساء و الأطفال، في حين تم استبدالها بلفظة ‘‘المؤسسات’’ في المادتين الخامسة و السادسة، التي يبدو عدم تحديدها أمرا مريبا سكت عنه واضع المشروع، في حين عيّن في المادة الرابعة، المنظمات المراد استدعائها، و هي تلك المعنية بقضايا المرأة و الطفل. ما يجعلنا نزعم أن المادة الرابعة كانت نوعا ما أوضح، في التنصيص على إمكانية حضور تمثيلية للمجتمع المدني، أشغال اللجنة الوطنية. على عكس المادتين الخامسة و السادسة، اللتين صيغتا بطريقة مبهمة، فالأعضاء المتطوعون من الشخصيات المعروفة باهتمامها بقضايا المرأة و الطفل، قد لا يكونون بالضرورة محسوبين على فعاليات المجتمع المدني، كما أنهم قد يحضرون بصفاتهم الشخصية أو الوظيفية، و ليس كممثلين عن هيئات المجتمع المدني. مثلا شخصيات سياسية أو برلمانية أو قانونية أو إدارية تهتم بقضايا الصحة و المرأة و الطفل، و ليس نشاطها الجمعوي شرطا لاستدعائها. و نفس الأمر ينسحب على الهيئات و المؤسسات المذكورة في المادتين السابقتين، فليس بالضرورة أن تكون هيئات تشتغل ضمن الفعاليات المجتمعية، بل قد تكون هيئات حكومية أو سياسية أو إدارية، أما لفظة المؤسسات، فحتما ليس المقصود بها الإطارات الجمعوية التابعة لهيئات المجتمع المدني، بل مؤسسات الدولة العمومية و شبه العمومية و مؤسسات القطاع الخاص. فدستور 2011 كان دقيقا في انتقاء المصطلحات الخاصة بكل مجال يراد تنظيمه، و هكذا ميز بوضوح بين المؤسسات و الهيئات باعتبارها آليات تابعة للدولة لتعزيز الحكامة و المواطنة و الديمقراطية و التنمية، و بين تنظيمات المجتمع المدني التي سماها في الفصل 12، بجمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية.
و هنا نتساءل، حول أسباب هذا الخلط الذي من شأنه أن يحدث التباسا كبيرا في ذهن القارئ من جهة، و أن يساء تفسيره لصالح استبعاد أي دور للمجتمع المدني، داخل اللجان الجهوية و المحلية من جهة أخرى. ثم ماذا كان سيضير واضع مشروع 103.13، لو أنه نصّ صراحة على إلزامية حضور منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا النساء و العنف، داخل أشغال اللجان على الأقل، مادام أسقط عنها العضوية الكاملة، إلى جانب ممثلي السلطات الحكومية و الإدارية الأخرى؟ عوض أن يرهن استدعاءها لقرار فوقي، تصدره لجنة متعددة الأطراف، بناءا على تقديرها الخاص لمدى حصول الفائدة من وراء هذا الحضور. و هنا يجوز التساؤل حول طبيعة هذه الفائدة، و ضوابط تكوّن تقديرها لدى مكونات اللجنة؟ و هل من ضمانات تنأى بها عن مزاج السلطة و أهواء السياسة؟
إن أية إستراتيجية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، لا يمكن أن تجد طريقها للتفعيل و الأجرأة، دون وجود شريك مجتمعي قوي، يمثل خط التماس الأول في جبهة المواجهة بين أجهزة الدولة و ظاهرة العنف. فقد كان على واضع المشروع أن يتدارك ‘‘خطأ’’ انفراده بصياغة و إعداد مشروع قانون 103.13، بالتنصيص صراحة على وجوب إشراك جمعيات المجتمع المدني، في أشغال كل اللجان الوطنية و الجهوية و المحلية، المكلفة بقضايا النساء و الأطفال. و إيلائها الأهمية المستحقة، عرفانا بمجهوداتها في هذا المجال، عوض التبخيس من أدوارها و تقييد مشاركتها –إن وجدت- بشرط حصول الفائدة، و ذلك بناءا على قرار صادر عن لجنة تجمع بين ثمانية متدخلين، تختلف مرجعياتهم حدّ التنافر، إذ كيف يمكن تحقيق التوافق حول مسألة استدعاء المجتمع المدني، أشغال لجنة تضم إدارات سيادية و أمنية، ظلت لعقود طويلة تناصب العداء للمجتمع المدني، بل و لا تعترف به أصلا؟
كان على واضع المشروع أن يتنبه لهذه المسألة، و يلزم اللجان بضرورة إشراك المجتمع المدني في أشغالها، و يترجم هذا الإلزام بعبارة ‘‘يجب’’ بدل ‘‘يمكن’’، و بهذا كان على الأقل سيضمن تمثيلية ملزمة بقوة القانون، للفاعل الجمعوي داخل أعمال اللجان. و بالتالي قطع الطريق أمام أي تأويل مغرض، قد ينتج عنه قرار إقصائي يجد سنده في مقتضيات مشروع القانون.
لخبطة تشريعية:
أقحم واضع المشروع قانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بابا خاصا بالأحكام الزجرية، يتألف من خمسة مواد، تنقسم بدورها إلى مجموعة من الفصول المضافة أو المعدّلة، لبعض مقتضيات القانون الجنائي. و نقول ‘‘أقحم’’ نظرا لأن أغلب مقتضياته عبارة عن تعديلات طفيفة، طالت القانون و المسطرة الجنائيين، ما يفرغه من محتواه كقانون قائم الذات وخاص بفئة معينة. و لعل أول ما يتبادر إلى ذهن القارئ و هو يطالع مواد هذا الباب، هو كثرة الإحالات التي و إن كانت تعتبر مزيّة في صناعة التشريع، تغني عن الإطناب و التكرار، إلا أن توظيفها يجب أن يكون رشيدا و مقيدا بضوابط الصياغة الجيدة، خدمة لوضوح النص و بلوغ مقاصده. فلا يجب الإفراط في استعمال الإحالات، تلافيا لما قد يلحق ذهن المتتبع من تشتت و التباس و ضبابية في الرؤية.
كما أن كثرة التعديلات و تكرار الفقرات، أسقطت المشروع في التعقيد، و أثرت على انسجام مقتضياته و اتساقها مع قواعد القانون الجنائي.
من ناحية أخرى، أضاف المشروع فقرة ثانية للفصل 1-503 من القانون الجنائي، و التي جرّم بمقتضاها التحرش الجنسي كجريمة قائمة الذات. على عكس منطوق الفقرة 1-503 التي كانت خجولة إلى حد ما في تجريم التحرش الجنسي، فاشترطت أولا توفر شرط الإكراه لقيامه، و ثانيا أن يكون ناتجا عن استغلال المتحرّش لسلطته المخولة له بطبيعة مهامه. و هو نفس ما سبق إليه المشرع الجنائي الفرنسي، الذي عرف التحرش بكونه ‘‘الفعل الذي يقع من خلال التعسف في استعمال السلطة باستخدام الأوامر و التهديدات، أو الإكراه بغرض الحصول على منفعة أو مزايا ذات طبيعة جنسية’’[22]، و إن كنا لا نتفق مع ما ذهب إليه كلا المشرعين المغربي و الفرنسي، من اعتبار أي تحرش من شخص على آخر ليس عليه سلطة، لا يعد تحرشا جنسيا. لأن تحرش رجل بامرأة لا ينبع فقط من كونه له عليها سلطة في العمل أو سلطة مادية، بل يمكن لهذه السلطة أن تكون اجتماعية يمنحها له المجتمع فقط لكونه رجلا. بيد أن التعديل المدْخَل على الفصل 1-503 بمقتضى المشروع الجديد، أقدم مرة أخرى على اقتحام مجال الفقه القانوني، و توزيع التعاريف الجاهزة، فعرف التحرش الجنسي بأنه ‘‘كل إمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية’’. و قبل هذا التعريف، أفرد لمرتكبيه عقوبة حبسية و مالية ، تتراوح بين شهر و سنتين حبسا، و غرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف درهم، مع الإشارة إلى أن واضع المشروع كان مرنا بحيث أعطى للقضاء هامشا لإعمال سلطته التقديرية، و الحكم بالعقوبتين معا، أو بإحداهما فقط.
و لعل اقتحام المشرع مجال الفقه كان له ثمن هذه المرة، فاستعمال عبارات مهلهلة يطرح صعوبات جمة، من حيث الإثبات و الأجرأة و التكييف، و بالتالي سيؤثر هذا سلبا على جودة الأداءين الضبطي و القضائي. و الأدهى أن يشرعن هذا القانون في حال المصادقة عليه، لجملة من التجاوزات الماسة بمجال الحريات و الحقوق الأساسية للمواطنين. نتيجة اتساع هامش التأويل و التفسير لبنود هذا القانون المتعلقة بالتجريم. فمثلا ما المقصود بالإمعان في مضايقة الغير؟ ثم ما هي حدود هذا الإمعان، أي الحد الفاصل بين ممارسة سلوك و الإمعان فيه؟ ثم لماذا تم التشديد على عنصر الإمعان، حتى يقع تجريم المضايقة، كما لو أن المضايقة وحدها ليست أهلا بالتجريم؟ ثم ما المقصود بالغير؟ ألا تفيد لفظة الغير الجمع بين الجنسين، و بالتالي لماذا يتم التنصيص على فعل جرمي، قد تقترفه المرأة ضد الرجل في مقتضيات قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء؟ ثم كيف يمكن اعتبار الإشارات إمعانا في المضايقة؟
من الملاحظ أيضا خرق المشروع لأحد أهم مبادئ الشرعية الجنائية، و هو مبدأ التناسب بين العقوبة و الجريمة، و هذا ما يستشف من منطوق الفقرة الثانية المضافة، و السالف ذكرها، إذ كيف يمكن الجمع بين أفعال تتعدد صورها ( أفعال، أقوال، إشارات)، و تختلف آثارها و درجات إيذائها بالنسبة للمرأة المتحرش بها، و تفريد نفس الجزاء لها؟
من المفارقات الأخرى التي تسترعي انتباهنا في هذه الفقرة المثيرة للجدل، و نقصد الفقرة الثانية المضافة للفصل 1-503 من القانون الجنائي، نجد أنه لا يمكن قيام جريمة التحرش الجنسي، إلا ضمن الفضاءات العمومية، و بالتالي لا يمكننا الحديث هنا عن تجريم لواقعة التحرش إلا إذا اقترنت بالفضاء العمومي، و بعبارة أوضح فالمشرع هنا لم يتدخل لتأثيم فعل التحرش لذاته، بل علّق ذلك على ارتكابه في مكان معين، فيكون اتصال هذا الفعل بذلك المكان شرطا لتأثيمه، كما أن وقوعه في غيره، يسقط وصف التجريم عنه.
و عليه، فإن المشرع اكتفى فقط بتجريم إحدى تمظهرات التحرش الجنسي، الممارس في الفضاءات العمومية، بينما لم يتدخل لتطويق امتداداته الأخرى في الفضاءات الخاصة. هذا ما يستدعي الوقوف و التساؤل بخصوص التحرش الممارس في المقاهي و الحانات و النوادي و المتاجر الخاصة، ألا يمكن اعتباره جريمة معاقب عليها؟
و من جهة ثانية يعاب على المشروع أيضا، وقوعه في الإجحاف، كونه يتحدث في الفقرة الثالثة المضافة للفصل 1-503 من القانون الجنائي، عن تشديد العقوبة لتصل الضعف، إذا كان المتحرش زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام و الأمن، و إن كنا نتفهم دواعي تشديد العقوبة في حق عناصر الأمن و حفظ النظام، لردع انفلاتهم في استغلال السلطة المخولة لهم بحكم طبيعة مهامهم، و هذا ما ينسجم أصلا مع منطوق الفصل 1-503 المعدّل بمقتضى القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي[23]. إلا أننا نرى أنه من الحيف الجمع بين التحرش الذي قد يمارسه عناصر القوة العمومية، و ذاك الذي قد ينتج عن علاقات زمالة في العمل، فالأول مقرون بالسلطة و النفوذ، أما الثاني فقد يكون مجرد إطراء أو مجاملة عادية قد تقع بين زميلين من نفس الدرجة الإدارية، و نذكّر هنا أن أغلب علاقات الزمالة كما جرت العادة، تنبني على قواعد المجاملات، فكيف يمكن التمييز بين هذه الأخيرة و التحرش؟ كما يلاحظ أن الفقرة الآنفة الذكر لم تفصح كفاية عن المقصود بزميل العمل، هل هو المتحرش الذي يعادل نفس الدرجة الإدارية للمتحرش بها؟ أم ذاك المرتّب في درجات أدنى منها؟ وفي كلتا الحالتين، ينتفي الإكراه و التهديد الناتج عن استغلال السلطة و النفوذ، كما أقره الفصل 1-503 من القانون الجنائي.
ناهيك عما قد يثيره هذا المقتضى في حال المصادقة عليه كما هو، من تأويلات قد يتم استغلالها بدناءة في تحفيز الشكايات الكيدية ضد زملاء العمل، و بالتالي سيؤثر هذا سلبا على أجواء العمل، التي من الواجب أن يسودها الإنسجام و الثقة.
و في نفس السياق، يمكن تسجيل ما وقع فيه المشروع من غموض و تناقض، و نخص بالذكر هنا، ما ذهبت إليه الفقرة الثانية المقترح إضافتها إلى الفصل 1-503، و التي عرفت جريمة التحرش الجنسي، بكونها كل إمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية سواء بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، لكن تأتي الفقرة الثالثة بعدها مباشرة، لتشدد العقوبة في حال كان المتحرش زميلا في العمل أو أحد أفراد القوة العمومية، و هنا نطرح السؤال التالي: هل تدخل أماكن العمل الخاصة ضمن الفضاءات العمومية ليتم تجريم التحرش فيها؟ لقد قيدت الفقرة الثانية قيام جرم التحرش، بوقوعه داخل الفضاء العمومي حصرا، بيد أن الفقرة الثالثة ناقضت ذلك، و جرّمت التحرش الحاصل بين زملاء العمل، الذي قد يكون ضمن فضاء خاص و مغلق.
هيمنة البعد العقابي الزجري على حساب المقاربات البديلة الأخرى:
تأسيسا على ما سبق، يبدو أن واضع المشروع، لم يفلح إلى حد بعيد، في بلورة مشروع متكامل الأهداف و الآليات، واضح الغاية و محكم الصياغة. يوائم بين المرونة و الشدة، و يجمع بين صرامة المتن و رجاحة العقل. فبعد طول انتظار الإفراج عن قانون يحارب العنف القائم على النوع، نفاجأ بمشروع مجزأ، مرتبك الصياغة و فاقد للرؤية، تشوب مقتضياته الكثير من الإختلالات الشكلية و الموضوعية. فمقاربة العنف ضد النساء تستلزم وضع استراتيجية متكاملة، منفتحة على كل الرؤى و المبادرات الفاعلة. و لم لا إطلاق حوار وطني، تُستثمر فيه كل إنتاجات المجتمع المدني في هذا المجال، مع ضرورة الانفتاح أكثر على الجامعة المغربية، عبر إشراكها الفاعل كقوة اقتراحية في هكذا استراتيجية. لما للبحث العلمي و الأكاديمي من أهمية كبرى في رصد و مقاربة و تحليل ظاهرة العنف القائم على النوع، مع اقتراح بعض مستلزمات محاربته.
إن مجابهة العنف ليست ورشا حكوميا، بقدر ما هي شأن جماعي يتطلب تضافر كل الجهود، فمحاربة العنف، عملية متكاملة تتآزر فيها أنظمة التشريع القانوني والحماية القضائية والثقافة الاجتماعية النوعية والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي الديمقراطي[24].
و طبعا لن يتأتى ذلك إلا عبر إفساح المجال للجميع، للمساهمة الفاعلة في إيجاد صيغة عمل مشترك و متكامل، لاستئصال جذور العنف. من خلال المشاريع التحديثية الفكرية والتربوية و السياسية والاقتصادية ، وفق ما تقتضيه القيم الحضارية و المبادئ الإنسانية السامية. لكن بطبيعة الحال، على الدولة أن تتحلى بالإرادة السياسية الجادة، و تعبئ الإمكانيات الكفيلة بضمان العيش الكريم للمواطنين على اختلاف جنسهم، نظرا لارتباط العنف بمظاهر الهشاشة السوسيواقتصادية. فاتساع رقعته يطّرد بشكل ميكانيكي مع ارتفاع معدلات الفقر، و ازدياد الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية. فمثلا تؤدي البطالة إلى مضاعفة المخاطر المؤدية إلى كل أشكال العنف، و هكذا فإن انتشار العنف الجسدي بين النساء العاطلات يبلغ 160% مقارنة بالنساء النشيطات. و من جانب آخر فإن معدل العنف الجسدي ضمن الحياة الزوجية، كما هو الحال ضمن الأسر التي يعيش فيها 4 إلى 5 أشخاص في كل غرفة، يتضاعف بمعدل 4 مرات مقارنة بتلك التي يعيش فيها فرد واحد في الغرفة ![25] .
فالهرولة نحو المقاربة القانونية و القضائية على حساب المقاربة الشمولية، من شأنه أن يفاقم الظاهرة أكثر، على اعتبار أن المغرب يحظى بترسانة قانونية ضخمة في هذا المجال، لكنها تبقى مجرد حبر على ورق. لمجرد الإستئناس أو للتوظيف السياسي في المحافل الحقوقية الدولية. ثم إن إشكالية العنف ليست في جوهرها قانونية، بقدر ما يعتبر القانون أحد مداخل معالجتها و ليس محاربتها، بحكم أنها ترتبط بأسباب وروافد تربوية واقتصادية واجتماعية، قبل أن تصبح مشكلة قانونية، لذا يجب البحث عن وسائل شمولية وعميقة لتطويقها وعلاجها، فأسلوب الزجر والعقاب والسجن، ليس دائما الحل الأمثل، بل قد يكون سببا في تفاقم المشكل وتمزيق كيان الأسرة[26].
هذا فضلا عن قصور السياسة الجنائية وحدها في مجابهة العنف ضد النساء، و تقديم الإجابات المقنعة و المعالجات الفاعلة للظاهرة. إذ لابد من وجود سياسات عمومية مندمجة تحقق الالتقائية على مستوى المنطلقات و الأهداف، و ترسم معالم استراتيجية شاملة للنهوض بأوضاع المرأة. تنطلق من دعم التمدرس و تنمية العالم القروي، من أجل خفض وتيرة الهجرة نحو المدن، و بالتالي الحفاظ على توازناتها الاجتماعية و الاقتصادية و السكانية. مع ضرورة إعداد خطة متكاملة لمحاربة مظاهر الخرافة و الدجل، و البدء فورا في تنفيذها، و أيضا نشر الوعي الحقوقي عبر اعتماد مناهج دراسية تستجيب للمعايير الدولية في مجال التنشئة الحقوقية. و كذا أنسنة المؤسسات السجنية و الإصلاحية و مراكز الإيواء، و ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى موظفيها، مع ضرورة توفير التأهيل الحقوقي لفائدة السجينات إلى جانب برامج التأهيل الأخرى، و على مستوى الإعلام العمومي، يجب إنصاف ذوات البشرة السوداء و منحهن فرص الظهور في تنشيط البرامج التلفزية و تقديم النشرات الإخبارية، و حثّ سوق الإشهار على ضرورة احترام كيان المرأة و حظر تسليع إنسانيتها، فالمرأة قبل أن تكون ضحية عنف طارئ موجه ضدها من طرف الرجل، فهي ضحية منظومة ثقافية و اجتماعية، تبرمج العقليات على مفاهيم تحقّر من المرأة، و تستبيح آدميتها و تهدر إنسانيتها. إن الإشكال في جزء منه يرتبط بمسألة العقليات الخاطئة التي يجب مصالحتها مع منظومة حقوق الإنسان الكونية، و أعطي مثالا هنا حول ما طرأ مؤخرا من تغيير على الفصل 475 من القانون الجنائي، و أكاد أجزم هنا، أننا سنظل نشهد رغم ذلك، زيجات تُرغم فيها المغتصبة على الزواج من مغتصبها، بإكراه من أسرتها درءا للفضيحة، و سترا للعرض.
إن تكريس النظرة العقابية و تغليب المقاربة الزجرية في قضايا العنف، الذي باتت بعض تجلياته تدخل ضمن السلوك الاعتيادي للمغاربة. سيترتب عنه لا محالة، اختلال خطير على مستوى النسيج المجتمعي، إذ ستزداد ظاهرة الجنوح البسيط استفحالا، في غياب مقاربات أخرى بديلة. فالعقوبات المنصوص عليها في المشروع، لا تتضمن عقوبات بديلة و جديدة، رغم النقاش المثار مؤخرا حول ضرورة اعتماد بدائل عقابية أخرى ضمن السياسة الجنائية الجديدة، إلا أن واضع المشروع قانون 103.13 ظل متخلفا عن ركب الإصلاح هذا، غير مستلهم لروح فلسفته، و مكرّسا لنفس الخلفية المتشددة التي تحكمت في صياغة القانون الجنائي. فهيمنت العقوبات السالبة للحرية على العقوبات المالية، التي جاء إقرارها شكليا في بعض المقتضيات. علاوة على أن الإكراهات الكثيرة التي تعرفها المؤسسات العقابية، بفعل الاختلال الحاصل في تدبير ملف الاعتقال الاحتياطي (43% من السجناء هم معتقلون احتياطيون)، بالإضافة إلى الاكتظاظ و ضعف الموارد و التجهيزات، ستزيد من مفاقمة أوضاعها سوءا، و بالتالي لن تكون قادرة على استيعاب أصناف جديدة من النزلاء الجدد، المتابعين مثلا بارتكاب جريمة التحرش الجنسي، باستعمال إشارات ذات طبيعة جنسية في حق زميلاتهم في العمل!
كان لزاما على واضع المشروع أن يتمثل مستجدات السياسة الجنائية، و يحاول تكييف مشروعه وفق فلسفة العقاب الجديدة، المعتمدة بالأساس على إيجاد بدائل جديدة للعقوبات، كالعقوبات المالية و الإدارية و المراقبة القضائية، و الشغل لأجل المنفعة العامة و غيرها.. بدل اعتماد آليات الزجر التقليدية، كالمؤسسات السجنية التي باتت مجرد مسكنات وقتية محدودة الفعالية، و عاجزة عن التموقع في موضعها الصحيح كأداة لمجابهة الظاهرة الإجرامية. لدرجة أن هذه المؤسسات و على غرار مثيلاتها لدى بعض الأنظمة المقارنة، لم تعد سوى مواقع لتجنيد محترفي الإجرام إن صح التعبير بذلك.. و لتأكيد مصداقية هذا التصور نستشهد بما ورد بالكتاب الأبيض المعد من طرف الحكومة البريطانية سنة 1990 و التي أقرت خلاله و بشكل صريح أن ‘‘السجن ما هو إلا وسيلة باهضة التكاليف لتحويل الأشرار إلى أشخاص أكثر شرا.. ’’[27].
الهوامش:
[1] مذكرة تقديم مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.ص4.
[2] البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، سنة2011.
[3] البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، سنة2011.
[4] كلاديس مطر،الذاكرة الشعبية و العنف المشروع ضد المرأة، مقال منشور في نشرة كنعان الإلكترونية، السنة العاشرة عدد 2194.
[5] راجع بهذا الخصوص :كتاب القول المأثور من كلام سيدي عبد الرحمان المجذوب، مكتبة الوحدة العربية، الدار البيضاء.
[6] كلاديس مطر،نفس المرجع السابق.
[7] موقع ديوان العرب، الأمثال الشعبية العالمية، تاريخ الزيارة16/02/2014.
[8] أبو إبراهيم الفارابي، ديوان الأدب، تحقيق الدكتور أحمد مختار عمر، و مراجعة الدكتور إبراهيم أنيس، الشركة المصرية العالمية للنشر.
[9] مذكرة تقديم مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.ص2.
[10] مداخلة بعنوان: دور خلية التكفل بالنساء و الأطفال في تطويق ظاهرة العنف الأسري للأستاذة ابتسام البكاوي، في أشغال الندوة المنظمة في رحاب المحكمة الابتدائية بفاس، في موضوع: العنف الأسري تجلياته و آثاره،يوم 28 فبراير 2013.
[11] مذكرة تقديم مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.ص4.
[12] كلاديس مطر،نفس المرجع السابق.
[13] انظر تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية السجون و السجناء الصادر في أكتوبر 2012.
[14] تحقيق صحفي بعنوان كوري بشري اسمه تيط مليل لمجيدة أبو الخيرات، منشور بجريدة الأحداث المغربية بتاريخ:13 يناير 2014.
[15] الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من الباب الأول من مشروع قانون 103.13.
[16] إدريس ولد القابلة، الاعتقال الاحتياطي هل هو ظلم لا مناص منه أم إجراء يمكن الحد منه؟ مقال منشور في موقع الحوار المتمدن، العدد 3927.
[17] حسب ما جاء في كلمة وزير العدل و الحريات، بمناسبة الاجتماع الأول للهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة.
[18] إدريس ولد القابلة،نفس المرجع السابق.
[19] حسب ما جاء في كلمة وزير العدل و الحريات، بمناسبة الاجتماع الأول للهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة.
[20] الفصل 12 من دستور 2011.
[21] البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، سنة2011.
[22] نزيه عبد اللطيف يوسف، تعريف التحرش الجنسي و موقف القانون المصري و القوانين المقارنة منه، مقال منشور في مدونة الوعي الثقافي بتاريخ يوليو 2011.
[23] و الذي ينص على أنه: يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أو أمر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية. ج ر عدد 5175 بتاريخ 05/01/2004 الصفحة 121.
[24] ذ.محمد بوزلافة، في مداخلة بعنوان: العنف ضد النساء و مداخل الإصلاح، على هامش أشغال الندوة المنظمة في رحاب المحكمة الابتدائية بفاس، في موضوع: العنف الأسري تجلياته و آثاره،يوم 28 فبراير 2013.
[25] حسب أهم و أخطر المؤشرات التي خلصت إليها نتائج البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء،المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، سنة2011.
[26] مداخلة الأستاذ فيصل الإدريسي،وكيل الملك بابتدائية فاس،في أشغال الندوة المنظمة في رحاب المحكمة الابتدائية بفاس، في موضوع: العنف الأسري تجلياته و آثاره،يوم 28 فبراير 2013.
[27] ذ.يوسف بنباصر،أزمة السياسة الجنائية بالمغرب: ظاهرة الجنوح البسيط كنموذج، رصد ميداني لتمظهرات الأزمة و دور المؤسسة القضائية في تكريسها و الحلول المقترحة لمعالجتها. دراسة قانونية منشورة في مجلة الواحة القانونية العدد 2 السنة 4.